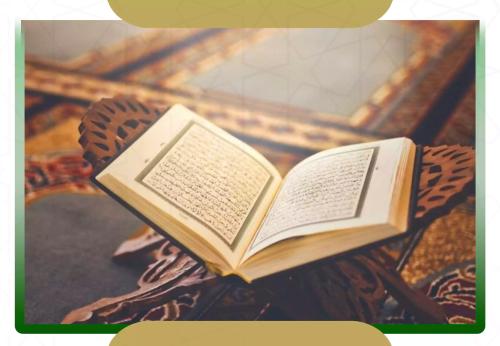
مختارات من كتاب (من روائع البيان في سور القرآن) (الحلقة 293)
( القسم الثاني )
(قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آَيَةً قَالَ آَيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَار) [آل عمران: 41]
ثانياً: لماذا جاء في إحداهما (ثلاث ليال) وفي الأخرى (ثلاثة أيام)؟
إنّ اختيارَ الليلِ في سورة مريم يقتضيه سياقُ القِصَّةِ وجَوُّها، وكذلك اختيارُ اليومِ في سورة آل عمران؛ وذلك للأمور التالية:
آـ قوله تعالى في سورة مريم: (إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا) [مريم: 3] حسّن ذكرَ اللَّيلِ، فإنّ خفاء النداء يشبه الخفاء في الليل، وإنّ الليل يخفي ما فيه بخلاف النهار، فإنه يفيد الظهور.
وممّا حسّن ذلك أيضا ذكرُ شيخوخته وضعفه، وهما أشبه شيء بالليل وما فيه من سُبات وسُكون وقلة حركة، وإذا كان لنا أنْ نقابل بين الإنسان والزمان، فإنّ الشباب أشبه شيء بالنهار وما فيه من حركةٍ، وإنّ الشيخوخة والضعف أشبه شيء بالليل وما فيه من سكون، لذلك ذكر شيخوخته ووهن عظمه مع الليل (قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا) [مريم: 4] (وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا) [مريم: 8] والعِتِيُّ المبالغة في الكبر ويبس العُود، ولم يذكر مع الأيام إلا قوله: (وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ) [آل عمران: 40]، فما ذكره في سورة مريم أنسب مع ذكر الليل.
ب ـ ثم إنه أشار في سورة مريم إلى طلبه وريثاً يرثه من بعده ويرث من آل يعقوب، والموت ليلٌ طويل وسباتٌ ممتد وفي الأثر: «النوم أخو الموت» قال تعالى في سورة الأنعام: (وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ) [الأنعام: 60] وهذا أقرب إلى الليل وذكره، وألصق به من ذكر النهار، ولم يذكر مثل ذلك في آل عمران.
ج ـ البشارة بيحيى في سورة آل عمران أكملُ وأعظمُ مما في سورة مريم؛ وذلك أنه:
قال تعالى في سورة آل عمران: (أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ) فوصفه (مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ) أي: مصدقاً بعيسى (وَسَيِّدًا وَحَصُورًا) وهو الحاصر نفسه عن الشهوات وعن المعاصي ونبياً من الصالحين؛ لأنه كان من أصلاب الأنبياء.
في حين لم يقل في سورة مريم إلا: (يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا) [مريم: 7] . ولعظم البشارة وكمالها اقتضى ذلك عِظَمَ الشكر وكماله.
1ـ قال تعالى في سورة آل عمران: (أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) [آل عمران: 41] وقال في سورة مريم: (آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ) [مريم: 10] واليوم أبين من الليل في ظهور هذه الآية، ذلك أنّ الليل يَمضي كثيرٌ منه في النوم، فزكريا عليه السلام لا بدّ أن ينام والناس أيضا ينامون، فالتسبيح والعبادة في الليل أقل منه في النهار، ومخاطبة الناس ومخالطتهم فيه أقل، فالآية في اليوم أطول وأظهر.
2ـ أنه في سورة آل عمران طُلب من زكريا عليه السلام أنْ يذكر ربه (وَاذْكُرْ رَبَّكَ) في حين طلب زكريا من قومه في سورة مريم أنْ يسبحوا، ولم يذكر أنه طلب منه التسبيح، وتسبيحه هو أدل على شكره.
3ـ أنه طُلب منه أن يذكر ربه كثيراً (وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا) وهذا شكر مناسب لعظم البشارة.
4ـ أنه طُلب منه الجمعُ بين الذكر الكثير والتسبيح (وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ) وهذا مناسب لعظم البشارة.
5ـ لمّا قدّم في سورة آل عمران المانع من جهة نفسه وهو الكبر على المانع من جهة زوجه، وهو العقر فقال: (وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ) ناسب أمره أنْ يقوم هو بالذكر والتسبيح، ولمّا قدّم في مريم المانع من جهة غيره (وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا) [مريم: 5] أي: أنّ هذا وصفها منذ شبابها، فالعقر وصف مستحكمٌ فيها وليس عارضاً، والولادة في مثل هذا أبعَدُ وأعجَبُ، فناسب ذكر غيره بالتسبيحِ وهم قومه.
6ـ لمّا ذكر الليل في سورة آية مريم (ثَلَاثَ لَيَالٍ) [مريم: 10] ناسب ذلك تقديم البكرة على العشي؛ لأنه بعد الليل تأتي البكرة، فأراد ألا يذهب من الوقت شيء في غير الطاعة والتسبيح، فقال: (بُكْرَةً وَعَشِيًّا) [مريم: 11]، ولو عكسها لكانت البكرة الأولى مضت من دون تسبيح.
ولمّا ذكر اليوم في سورة آل عمران (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) كان تقديم العشي أولى، ولو قدّم البكرة لذهب عشي اليوم الأول من دون ذكر وتسبيح.
7ـ إنّ البشارة في سورة آل عمرانَ حصلت وهو قائمٌ يصلِّي في المحرابِ في حين لم يذكر ذلك في سورة مريم، بل علمنا من فحوى الكلام أنّ البشارة كانت وهو في المحرابِ بدليل قوله: (فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ) [مريم: 11]، ولا يقتضي كونه في المحراب أنه كان يصلي، فذكر في آل عمران الحالة الأكمل التي كان عليها سيدنا زكريا، وهو المناسب لعظم البشارة وكمالها.
8ـ أنّ البكرة والعشي نكرتان في مريم معرفتان في سورة آل عمران، ويذكر المفسرون أن (أل) تفيد العموم، وقد ورد نحو ذلك في عدة آيات منها:
ـ (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ) [غافر: 55] (إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ) [ص: 18].
ـ (فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ) [فُصِّلَت: 38]، وهذا يدل على العموم والاستمرار. وعلى تطاول مدة الذكر والتسبيح، وهو مناسب أيضا لعظم البشارة.
بينما النكرة (بُكْرَةً وَعَشِيًّا) [مريم: 11] تفيد يوماً محدداً، تقول سافرت صباحاً أي: اليوم بالتحديد صباحاً، لكن عندما تقول: أسافر في الصباح: فهذا يدل على العموم والاستمرار.
9ـ قوله تعالى: (آيَةً) [مريم: 10] أي: علامة، وطلبها زكريا عليه السلام للأمور التالية:
آ ـ للاطمئنان، كما قال إبراهيم عليه السلام: (وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي) [البقرة: 260].
ب ـ استعجال السرور.
ج ـ طلب العلامة ليتلقى الأمر ويبدأ بالشكر كي يسبق به قبل قدوم الغلام.
والله أعلم.
ملحوظة : تتمة النقاط في الآية سنذكرها في الحلقة القادمة بإذن الله .
بقلم: مثنى محمد هبيان
تنويه:
جميع المواد المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِّر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين
مقالات ذات صلة



